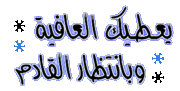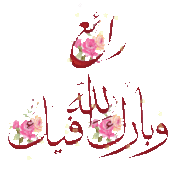غالبا ما يصيب مرض (Home sickness) والمعروف بالحنين إلى الوطن، الذين يعيشون أو يقيمون
في المنفى، وبأنواعهم المختلفة، طالبي اللجوء أو العاملين في الخارج، ولا يستثنى حتى
السائحين منهم، ذلك لإبتعادهم عن وطنهم، وعن أهلهم وذويهم. فيفرض عليهم الحنين إلى
الوطن لوعته التي تصيبهم حد الكمد والكآبة والمرض الاكيد.
لكن الغريب في الأمر ان الإنسان العربي وحده الذي يصيبه هذا المرض في عقر داره، وربما الفرد
العراقي أنموذجا رائعا لهذا المرض، ومادة إعلانية خام له.
جاء كل ذلك نتيجة التراكمات من الأحكام التعسفية التي تقوم بها المنظومات الحاكمة في المنطقة
العربية، من تسلط وجور، وسلب وغمط للحريات الشخصية، مع جانب كبير من اختزال للرأي
ومصادرة تامة للفرد العربي. إضافة إلى ذلك عنصر مهم جدا، وهو قتل الشعور والحس الوطني. ورب
سائل يقول كيف ذلك؟ فقتل الروح الوطنية لا تنتج بالتالي شعورا حماسيا اتجاه الوطن، أو توليد
شعور ذهني لحب الوطن والانتماء له.
هذا صحيح على مستوى علاقة الفرد بالوطن، ومدى خدمته لوطنه، فنرى ان أكثر الدول تأخرا تلك ا
لتي يشعر فيها الفرد المواطن بعدم انتمائه او انه فاقد لعنصر المواطنة، بيد ان في الحالة هذه
ستنشأ حالة مغايرة جدا، وعميقة للحد القاتل في التصور للوطن البديل الداخلي الذي يراه الفرد.
من الناحية السايكولوجية النفسية تراه اشد المدافعين عن هذا الوطن ـ الافتراضي التصوري ـ وهو
يحبه ويؤمن به، ولكن من الناحية التطبيقية العملية، يفقد مكونات وعناصر هذا الوطن على الأرض
الواقعية، فتكون صورته مشوهة وضبابية، أشبه بالجنين ناقص التكوين.
والحال هذه سيكون ازدواجيا في المعيار الذهني، فهو يمتلك الوطن الذي لا يعترف به ولا يحترم
مواطنته فيه، من جانب، ومن جانب آخر الركوع والخضوع إلى المخيلة الافتراضية في ذاته أو ما
يمكن ان نطلق عليه بـ (الوطن الافتراضي) الذي يحن ويصبو إليه، وهو الذي يسوقه إلى المرض الذي ذكرناه ابتداء
هذا التداخل الذهني من شأنه التسبب بالتشويش الكامل في مناطق فعاليات الإدراك الغير
الواعية، مما يكون ناتجه بطبيعة الحال تداخلا سلبيا، على المحيط الخارجي والداخلي. مثل احترام ا
لأرض والوطن، والعمل على النهوض والتقدم والخدمة العامة التي يقدمها الفرد للمجتمع. كل هذا
يأتي من الشعور التام بالانتماء، وخلاف ذلك وفي الحالة التي ذكرناها من عدم الانتماء سيكون
عكس ما تقدم في العمل على مستوى رقعة الوطن فيكون الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية.
هذا الانعكاس بالضرورة للفرد والذي ينتج عن هذا التداخل هو حالة من عدم الاستقرار الذهني.
ففكرة العيش والحياة والشعور بالمسؤولية، والتضحية، تنتج وبالدرجة الأولى من الشعور التام
بالمواطنة وامتلاك عناصرها الكاملة، وهي ليست مثالية كما يُعبر عنها، او يحاول البعض ان يصفها
في محاولة لتجريدها من محتواها الواقعي، وإفراغها، إنها حالة اجتماعية ثابتة لايمكن التخلي أو
التنصل عنها، وبخلاف الشعور بالمواطنة تدب الفوضى التامة.
بالتالي يكون الناتج خطيرا جدا في الحسابات المنطقية، إذ ما جدوى ان يمتلك أحدنا (وطن
افتراضي) فقط، فهذا لا يحقق الغاية التي تنشدها الأمم بجميع الأحوال، فلا نحن نصل إلى وطننا
الوهمي الذي صنعناه في دواخلنا في يوم ما، ولا فَعّلنا دورنا على الأرض التي نعد أنفسنا غرباء
عنها، في حين هي الوطن الحقيقي لنا، وكل من سلبها من داخلنا ما هو إلا طارئ عليها وعلينا، ا
لمهم ان نكون نحن فتكون هذه الأرض؛ الوطن، فالاثنين امتداد تام (المواطن والوطن). فالأول يصنع ا
الثاني، والثاني يضم الأول
في المنفى، وبأنواعهم المختلفة، طالبي اللجوء أو العاملين في الخارج، ولا يستثنى حتى
السائحين منهم، ذلك لإبتعادهم عن وطنهم، وعن أهلهم وذويهم. فيفرض عليهم الحنين إلى
الوطن لوعته التي تصيبهم حد الكمد والكآبة والمرض الاكيد.
لكن الغريب في الأمر ان الإنسان العربي وحده الذي يصيبه هذا المرض في عقر داره، وربما الفرد
العراقي أنموذجا رائعا لهذا المرض، ومادة إعلانية خام له.
جاء كل ذلك نتيجة التراكمات من الأحكام التعسفية التي تقوم بها المنظومات الحاكمة في المنطقة
العربية، من تسلط وجور، وسلب وغمط للحريات الشخصية، مع جانب كبير من اختزال للرأي
ومصادرة تامة للفرد العربي. إضافة إلى ذلك عنصر مهم جدا، وهو قتل الشعور والحس الوطني. ورب
سائل يقول كيف ذلك؟ فقتل الروح الوطنية لا تنتج بالتالي شعورا حماسيا اتجاه الوطن، أو توليد
شعور ذهني لحب الوطن والانتماء له.
هذا صحيح على مستوى علاقة الفرد بالوطن، ومدى خدمته لوطنه، فنرى ان أكثر الدول تأخرا تلك ا
لتي يشعر فيها الفرد المواطن بعدم انتمائه او انه فاقد لعنصر المواطنة، بيد ان في الحالة هذه
ستنشأ حالة مغايرة جدا، وعميقة للحد القاتل في التصور للوطن البديل الداخلي الذي يراه الفرد.
من الناحية السايكولوجية النفسية تراه اشد المدافعين عن هذا الوطن ـ الافتراضي التصوري ـ وهو
يحبه ويؤمن به، ولكن من الناحية التطبيقية العملية، يفقد مكونات وعناصر هذا الوطن على الأرض
الواقعية، فتكون صورته مشوهة وضبابية، أشبه بالجنين ناقص التكوين.
والحال هذه سيكون ازدواجيا في المعيار الذهني، فهو يمتلك الوطن الذي لا يعترف به ولا يحترم
مواطنته فيه، من جانب، ومن جانب آخر الركوع والخضوع إلى المخيلة الافتراضية في ذاته أو ما
يمكن ان نطلق عليه بـ (الوطن الافتراضي) الذي يحن ويصبو إليه، وهو الذي يسوقه إلى المرض الذي ذكرناه ابتداء
هذا التداخل الذهني من شأنه التسبب بالتشويش الكامل في مناطق فعاليات الإدراك الغير
الواعية، مما يكون ناتجه بطبيعة الحال تداخلا سلبيا، على المحيط الخارجي والداخلي. مثل احترام ا
لأرض والوطن، والعمل على النهوض والتقدم والخدمة العامة التي يقدمها الفرد للمجتمع. كل هذا
يأتي من الشعور التام بالانتماء، وخلاف ذلك وفي الحالة التي ذكرناها من عدم الانتماء سيكون
عكس ما تقدم في العمل على مستوى رقعة الوطن فيكون الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية.
هذا الانعكاس بالضرورة للفرد والذي ينتج عن هذا التداخل هو حالة من عدم الاستقرار الذهني.
ففكرة العيش والحياة والشعور بالمسؤولية، والتضحية، تنتج وبالدرجة الأولى من الشعور التام
بالمواطنة وامتلاك عناصرها الكاملة، وهي ليست مثالية كما يُعبر عنها، او يحاول البعض ان يصفها
في محاولة لتجريدها من محتواها الواقعي، وإفراغها، إنها حالة اجتماعية ثابتة لايمكن التخلي أو
التنصل عنها، وبخلاف الشعور بالمواطنة تدب الفوضى التامة.
بالتالي يكون الناتج خطيرا جدا في الحسابات المنطقية، إذ ما جدوى ان يمتلك أحدنا (وطن
افتراضي) فقط، فهذا لا يحقق الغاية التي تنشدها الأمم بجميع الأحوال، فلا نحن نصل إلى وطننا
الوهمي الذي صنعناه في دواخلنا في يوم ما، ولا فَعّلنا دورنا على الأرض التي نعد أنفسنا غرباء
عنها، في حين هي الوطن الحقيقي لنا، وكل من سلبها من داخلنا ما هو إلا طارئ عليها وعلينا، ا
لمهم ان نكون نحن فتكون هذه الأرض؛ الوطن، فالاثنين امتداد تام (المواطن والوطن). فالأول يصنع ا
الثاني، والثاني يضم الأول